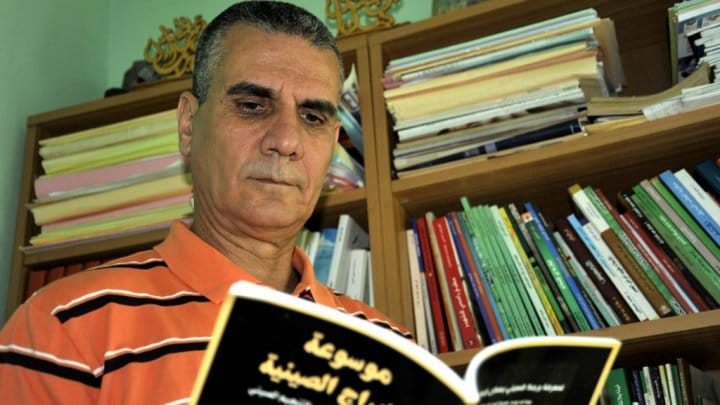بقلم . عبدالعزيزالخطابي
في زمن الأسئلة الصعبة ،هناك أسئلة خارج المألوف تكون عادة هي الأصعب ،من بين هذه الأسئلة مدى إحساس الجماهير العربية بالإرهاق من واقعها الحالي وبأزمتها في علاقاتها بالعصر وتحدياته مما جعل هناك خوفا دائما ،نفسيا وظاهرا أحيانا كثيرة قائما بينها وبين الحالة السيئة التي هي فيها والحالة الأسوأ التي تخشى أن تبلغها.
لكن كيف يمكن للجماهير العربية أن تخرج من هذا الباب المغلق ؟ ولماذا الاستبداد السياسي يزداد انتشارا؟ وقدرة الأقوياء على التحكم بضعف الضعفاء تزداد قوة ؟ والنضال من أجل كسب معركة حريات الفكر يزداد صعوبة ،فالجرأة في التطلع إلى الفكر الحر الديمقراطي باب الاجتهاد مفتوح فيه وباب الصراع بالمناقشة والحوار والاستنباط مسموح فيه أصبحت معدومة ولم تعد الكلمة التي كانت في البدئ هي التي ستكون حتما في النهاية.
اتسعت الهوة بين هذه الجماهير وبين كتابها ومثقفيها إلى درجة أصبح من الصعب استنباط أسلوب يستطيع الكتاب والمثقفون من خلاله أن يوصلوا إلى هذه الجماهير التي ينتمون إليها الأفكار التي يدعون لها والآراء التي ينظرون فيها بطريقة قادرة على استيعابها.
وفشلت الطروحات الفكرية بمختلف اتجاهاتها في أن تؤصل الدعوة إلى الديمقراطية ،بينما ظلت الجماهير العربية تعيش حالة من التيه الطويل في بحثها عن منقذ ،ولأن الأرض قاحلة والتجربة فقيرة ظلت الهوة قائمة بين الفكر العربي الحديث والديمواقراطية كقضية محورية تشغل تفكيره حتى بعد احتكاك المجتمع العربي بالغرب وذلك في أدق اللحظات التاريخية صرامة.
الديمقراطية العربية تاريخا
كانت حكومة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ،آخر حكومة ديمقراطية عرفها العرب ،ولهذا السبب فأن نموذج الحاكم الديمقراطي في ثقافتنا العربية يبدو قديما جدا وغير قابل للترجمة بلغة العصر ، والتراث العربي لا يملك نموذجا آخرا يستحق الذكر ولا يعرف من مظاهر الشرع الجماعي سوى هذه الصيغة الفردية المبكرة.
وإن أربعة عشر قرنا من الإسلام لم تنتج في واقع العرب سوى حكومة إسلامية وحيدة.ففي ظروف هذا الفشل الإداري المزمن،يعايش العرب تجربة حضارية أشبه بالكارثة في ثلاث جوانب على الأقل ،فمن جهة لا يفتقر العرب إلى إدارة ديمقراطية فحسب،بل يفتقرون إلى لغة النظام الديمقراطي نفسه.إنهم يترجمون عن الغرب مصطلحات مثل (برلمان – معارضة – محكمة عليا- دستور- وأحزاب) .وهي عن مفردات رأسمالية.
وهنا يطرح علينا تساؤل هام :ماهي إشكالية الديمقراطية في الوطن العربي؟.
لاشك أن المهمة هنا صعبة،لأن الحديث عن الديمقراطية في وطن لا يدرسها نظريا دراسة معمقة،ولم يمارسها عمليا بأي شكل من الأشكال منذ بدأت ممارسة ما يسمى بالديمقراطية.
ورغم ذلك فأنه علينا أن نبدأ فنقول : إن المقصود بالديمقراطية طريقة الحياة وأسلوب الحكم الذي يقوم على أساس قيام السلطة على إرادة الشعب وممارسة الشعب حريته وحقه في اختيار السلطة التي تحكمه بطريقة يقبلها، وضمان حقوقه الأساسية ،السياسية والاجتماعية ،حقوقه في المساواة وحرية التعبير والتنظيم والعمل والمشاركة في صياغة الحياة السياسية والاجتماعية.
وإذا كان ينظر إلى الديمقراطية على أنها شكل سلطة فإن فكرة الديمقراطية اتسعت باضطراد في الآونة الأخيرة،وما كان في الأساس مبدأ سياسيا وسع ليشمل أفكار اجتماعية واقتصادية وأخلاقية.
ولقد مارست الماركسية النظرية نقد الديمقراطية البورجوازية مارست الماركسية العملية في تجارها المختلفة بناء نظام مختلف نوعيا وباسم ديكتاتورية البروليتاريا أو الديمقراطية الجديدة.
ثم مارست الماركسية العملية نقد تجربتها مع الثورة الثقافية في الصين وهي الآن تمارسها ممارسة أوسع وأعمق مع البرويسترويكا.
وهاهي النظرية العالمية الثالثة ،تعلن بطلان النظريتين البورجوازية والبروليتارية، الممارستين، وتبشر بمجد الجماهير، ديمقراطية الجماهير المباشرة.
ومن خلال ما تقدم نجد أن ذلك كله يطرح الإشكالية ولا يحلها ،لأن مشكلة الديمقراطية ليست مشكلة رياضية أ معادلة هندسية وبالتالي فإن محاولة تحديده بشيء ومحاولة حلها بشيء آخر،إن محاولة تعريفها وتحديدها مسألة نظرية وبالتالي فإن فيها كل ما في القضايا النظرية من تجربة وتعقيد ، ولكنها رغم ذلك تظل قابلة للفهم.
إلا أن حل هذه المشكلة يرتبط بقوى اجتماعية معينة في وطن محدد ضمن ظروف محلية،وعالمية محددة ،وإذا كان هذا يعقدها عمليا فأنه يترك تعقيداته النظرية فيها، إذ أن ارتباط المسألة بصراع القوى الاجتماعية يجعلها متجددة دائما ،ترفض المقاييس الثابتة والمعايير الجامدة ولا تقبل محاولات النقل والتقليد وهذا ما لا يهتم به كثير من دعاتها.
ما الديمقراطية إذا ؟
إنها سلطة الشعب بالطريقة التي رياها صالحة.
وهذه الطريقة قابلة للتغيير وبمقدار تطور وعي الشعب وتطور قدرته على ممارسة حريته ويرتبط ذلك بمقدار التطور الاجتماعي فقط وكان طبيعيا أن يرتبط وعي مسألة الديمقراطية وممارستها بنشوء المدن وما كان ممكنا أن تعرف ما سمي الديمقراطية اليونانية خارج إطار المدن اليونانية .
ثم إن التطور المدني حمل لنا تطور أشكال الديمقراطية العملية ،فبدأت بالملكية الدستورية ثم الجمهورية وحقوق المواطن والإنسان ثم الجمهورية الاشتراكية التي تفرض المساواة الاجتماعية مع ثورة أكتوبر،ثم محاولا تخطي ديكتاتورية البروليتاريا في الصين سنة 1977، إلى عصر الجماهيريات في الجماهيرية العربية الليبية 1980 وفي الاتحاد السوفياتي 1970 ،تحولات البروسترويكا.
ورغم النكسات والتراجعات ظل المواطن يكسب المزيد من الحقوق وازدادت الهيئات المشاركة في الحد من سلطة الدولة، وفي زيادة دور الجماهير في صنع القرار السياسي.
لقد اضطر نمط الدولة الرأسمالية أن يقدم تنازلات كبرى للشعب عامة،والطبقة العاملة خاصة.وهاهو نمط الدولة الاشتراكية يضطر لتقديم تنازلات كبرى لجماهير الشعب ومنها التنازل عن حكم الحزب الواحد والإيديولوجية المهيمنة.
أما في العالم الثالث ماعدا استثناءات قليلة فإن الدولة مازالت وحشية رغم التأثيرات العالمية ،ويعود ذلك من جهة نظري إلى .
– إن الفئة الحاكمة في هذه الدول سواء كانت ممثلة عائلات حاكمة وراثيا أو حكومات انقلابية أو بورجازيات وصلت السلطة بالانتخابات ،لا تنتسب لأي تراث ديمقراطي نظريا أو عمليا.
فالنخب التي حاولت أن تقلد المخطط الرأسمالي في الدولة كانت تقلد ولم تكن تمثل طبقة رأسمالية منتخبة ولا كانت تواجه قوى إنتاج قادرة على فرض احترام حقوقها لما كانت هذه النخب تابعة للاقتصاد الرأسمالي العالمي،فأنها لا تستطيع أن تكون ديمقراطية في أقطارها.
والنخب التي تبنت الحل الاشتراكي كانت نخبا غير مؤهلة لوعي مسألة الديمقراطية وكانت في الوقت عينه تقتدي بنمط الدولة الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية سابقا.وهو نمط غير ديمقراطي في ممارسة السلطة وإن كان يبني دون عي منه أساس الثورة الديمقراطية.
– أن مجتمعات العالم الثالث لم تحقق الاندماج القومي ولم تبن القاعدة الاقتصادية ولم تنجز ثورتها الديمقراطية بعد. وقد اتجهت القيادات إلى محاولة بناء القاعدة الاقتصادية وبناء الدولة ولذلك اتجهت إلى فرض سلطة الدولة دون أي اعتبار.
ولما كانت هذه القيادات في الأغلب قيادات غلبة واستيلاء وكانت تخشى التعدد الداخلي( طائفي ،اثني،ديني،سياسي) وتخشى المناورات الخارجية سواء كانت امبريالية أو مناورات دول الجوار فقد اتجهت إلى بناء نظام واسع السطوة.
أن تأثيرات التيارات العالمية ،رأسمالية ،شيوعية، دينية ،كانت تخيف هذه القيادات الحاكمة وتدفعها إلى مزيد من التشدد.
وعليه فأن الديمقراطية تتجه إلى التجسيد في أشكال جديدة في العالم الصناعي أما في العالم الثالث فأن تخلف البنى عموما وتشوه النخب وتهدم البنى الاجتماعية سيقود إلى مجازر وأنظمة قمع.
وبناء مراكز مدنية وسط عالم التخلف وانتشار الأفكار المتعلقة بحقوق المواطن والإنسان والمعلومات عن الحرية والديمقراطية في العالم سيقود إلى تنامي حركة الحرية والديمقراطية وستأخذ هذه الحركة طابعا أكثر عمقا وشمولا فيها في أي وقت مضى.
إذن، هل المشكلة بتعريف الديمقراطية وتحديد مفهومها؟
إن فيها شيء من ذلك؟ لأن التعريف والتحديد يساعدان على الفهم، والفهم يساعدنا على معرفة ما نريد،وهذا ضروري لخوض المعركة ،وإن كانت معارك الديمقراطية قد ضبطت دائما، دون مثل هذا الوضوح لأن مثل هذا الوضوح موضع صراع مستمر مع استمرار التطور الاجتماعي واستمرار تطور المفاهيم وصراع الأفكار ولأن التفاوت على الصعيد العالمي واختلاف متطلبات المجتمعات يثير أكثر من قضية في هذا المجال.
إلى جانب أنها تمثل إشكالية نخبة أيضا، فالدولة تتطلب بالضرورة نخبة سياسية تقودها. وهذه النخبة ” يحدث أحيانا أن تولى الطبقة الاجتماعية الحاكمة إفرازها، ويحدث في أحيانا أخرى أن تتولى النخبة إفراز الطبقة “. والنخبة العربية أصابها العقم أو الشلل، فمنذ فترة طويلة وإلى الآن ورغم ذلك فالحياة الاجتماعية تفرز النخب دائما وفي كل العصور، فما الذي يجعل نخبا ديمقراطية وأخرى غير ديمقراطية؟.
وللإجابة على هذا التساؤل نقول إن النخبة جزء من التطور الاجتماعي، ولكل طبقة وفئة حاكمة أو غير حاكمة نخبتها. وبما أن النخبة جزء من المجتمع فهي تكتسي قوتها وإبداعها فيه والناجمة عن قوة طبقتها أو فئتها التي تنمو النخبة من لحمها ودمها ومن إبداعها وهذا يعني أن النخبة التي أحاطت بالسلطان عبد الحميد لا تستطيع أن تكون غير أبو اليزيدي الصيادي ، ونخبة كل ملك أو أمير من القوى الاجتماعية التي تخدمه وتمثل قوى سلطته.
ولقد كانت النخب التي أحاطت بالانقلابيين العرب من أحمد عرابي وحتى الآن هي من القوى الاجتماعية التي يمثلها هؤلاء الانقلابيين.
ومما تقدم نستطيع القول أن مشكلة النخبة في المجتمع ليست إلا جزء من مشكلة التطور الاجتماعي.
وقضية الديمقراطية في الوطن العربي شأنها في كل العالم الثالث لا تحلها نصائح النخبة ولا تجربتها السلطوية. فأن لم تخص معركة الديمقراطية جماهير الشعب العاملة والكادحة ، ذات المصلحة في الديمقراطية فأن ملوك هذا الزمان ورؤساء الجمهورية القياصرة لن يقدما الديمقراطية للجماهير على أطباق من ذهب ولن تستطيع النخب المحيطة بهم أو الساعية للالتحاق بهم أن تنفعهم بنصائحها ليكونوا ديمقراطيين.
إلا أن المسألة ليست بهذا الوضوح نظريا وعمليا.
فمن الناحية النظرية ،ماهي طبيعة البرنامج الديمقراطي للشعب؟ مثل الشعب العربي يواجه قوى كالكيان الصهيوني والإمبريالية الأمريكية ومخاطر خارجية متنوعة.
مثل الخطر الإيراني والتركي ويواجه أيضا مشكلة التجزيء القومية والتبعية الاقتصادية للاقتصاد الرأسمالي العالمي، وكيف تكون الثورة الديمقراطية عندما يتحد الأعداء الخارجيون ، وعلى رأسهم الإمبريالية الأمريكية والأعداء الداخليين ،الأنظمة المرجعية والقوى الطائفية؟.
ومن الناحية العملية من هي القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة في الثورة الديمقراطية ؟ وكيف يمكن أن نتحد؟ بأي برنامج؟ وأية قيادة؟.
لقد طرح برنامج الثورة الاشتراكية سواء بقيادة الأحزاب الشيوعية أو الأحزاب القومية ولم يتحقق،ولم يطرح أحد برنامج الثورة الديمقراطية ،فاي برنامج تطرح الآن بعد فشل تجارب الوحدة القومية والتنمية الاقتصادية،إلى جانب تجارب العنف والقمع؟.
إننا مطالبون اليوم بالإجابة على هذه الأسئلة ،لأن الديمقراطية حديث العالم اليوم.ودول العالم المتمدنة تشهد التطورات المتتالية في هذا الاتجاه ،فأين نحن العرب من ذالك؟.
إننا ما زلنا بعيدين كثيرا عن ذلك ،ورغم الأحاديث المتنوعة عن الديمقراطية ورغم بعض الإجراءات هنا هناك كما جرى في الجماهيرية والأردن في المرحلة الأخيرة ،فلماذا تنطلق الثورة الديمقراطية في موسكو وبكين غيرها من بلدان العالم ونبقى نحن خارج العالم؟.
إن هذا يعود للأسباب التالية
– لقد حققت مجتمعات بلدان العالم حدتها المجتمعية فضعت الأساس السياسي الاجتماعي لدولة مدنية،فأصبحت الدولة الديمقراطية مطلبا شعبيا حتى في الأحزاب الحاكمة ،كما أنها لم تخضع لاحتلال أو لحكم قوى رجعية متخلفة من القرون الوسطى ولديهم آلية إنتاج ولو كانت تعاني من خلل وبالتالي فإن الديمقراطية باتت مطلبه الراهن.
إلى جانب أن تلك الشعوب خاضت معارك بناء الدولة والمجتمع دفعت تضحيات باهضة،وعرفت نظام الحزب الواحد ،والطابور الطويل ،والمعاناة القاسية كما عرفت ذلك أوربا الغربية قبل ثورتها الديمقراطية.
أما نحن فلا زلنا لم نحوز مجتمعا ولم نوحده ولم نبن الأساس الاقتصادي ولا الأساس السياسي لدولة معاصرة.
– إن الجماهير في الإتحاد السوفياتي سابقا وأوربا الشرقية لم تكتف بما حققت وهي تريد أن تدخل العصر وان تخوض معاركه،ولذلك فإنها تتأهل لإحداث ثورة عميقة في دور السلطة والحزب تجعل إرادة الشعب أساس كل سلطة وكل قانون .وهي كذلك لا تريد إسقاط حكم الحزب الواحد فقط ،ولا إعلان التعددية السياسية فحسب بل تطالب بأن تكون إرادة الشعب مصدر كل قرار منبع كل سياسة.
وهي لذلك تبني أحزابا وقوى جديدة.وتطرح برامج جديدة ورغم التشدد في المواقف والتضارب في الاتجاهات فأن الهدف هو هذا النمط الديمقراطي أو ذاك.
أما الجماهير العربية فما زالت غير قادرة على رص صفوفها وتحقيق وحدتها وخوض معاركها الفاصلة أ على بناء الأساس المادي المعنوي لمجتمع مدني معاصر.
لا يمكن أن يحدث هذا التحول الذي تنشده إلا عندما تصبح الجماهير قادرة على ذلك يمكن للجماهير أن تصبح قادرة إذا توافرت لها الشروط التالية :
الشرط الأول طلائع سياسية ونقابية وثقافية تجسد هذه المطامح تعبأ الشعب وتبلور البرامج، وتخوض الصراع السياسي والإيديولوجي والثقافي العسكري في مواجهة القوى المعادية الشرسة.
إن دور الحزب يجب أن يصنف حيث قام المجتمع المدني لمصلحة الجماهير الواسعة، وعلى الطلائع السياسية والنقابية الثقافية والعسكرية تجنيد قواها لإزالة العوائق التي تمنع الشعب من تحقيق إرادته، وألا تعتبر نفسها وريثة للسلطة التي تحاربها ولا وصية على إرادة الشعب .
ولكي تكون كذلك يجب أن تكون بينها ديمقراطية وأن تكون الثورة الديمقراطية جوهر برنامجها وأن تثبت بالممارسة ذلك.
الشرط الثاني ضرورة قيام جبهة قومية تضم بين صفوفها كل القوى الملتزمة حقيقة بأهداف الجماهير وتتكون هذه الجبهة من كل القوى الديمقراطية.
وتنبع ضرورة هذه الجبهة باعتبارها ضرورة لحشد قوى الشعب الواسعة وطلائعه المختلفة ومن أجل تكريس مبدأ التعددية السياسية قبل ووصول السلطة وفرض التعددية السياسية على السلطة عند تسلمها أو انتزاعها. من هنا وجود هذه الجبهة ضروري لتحقيق الثورة الديمقراطية لبناء سلطة ديمقراطية تقوم على إرادة الشعب.
الشرط الثالث جماهير واعية تخوض معاركها وتدافع عن مصالحها ومطامحها وتحارب كل قوة تحاول فرض سيطرتها عليها .والجماهير لن تكسب هذه الإرادة إلا بالتدريب على خوض المعارك وبالتعبئة السياسية والديمقراطية بامتلاك الوعي الثوري.
إن هذا كله ضروري لإعداد الجماهير العربية لتحقيق أهدافها، ويزيد من ضرورة ذالك ما يلي :
– إن بناء مجتمع عربي مدني، يتطلب تحقيق الوحدة القومية ،التي يستحيل دونها بناء صناعة متطورة وزراعة متقدمة وحل مشاكل التنمية وهذه الوحدة تواجه عقبات كبرى من الإمبريالية عامة، والأمريكية خاصة، إلى الاحتلال الصهيوني ومن الدول القطرية إلى القوى المرجعية المنادية للوحدة.
– إن بناء مجتمع عربي مدني، أيضا، يستلزم تحرير الأرض العربية من الاحتلال ومن كل أشكال التبعية المباشرة وغير المباشرة وهذا لن يتحقق دون معارك كبيرة.
– إن بناء المجتمع العربي المدني، فق هذا وذاك يحتاج إلى تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي يحررنا من التخلف والتبعية،ويوفر متطلبات الحياة الكريمة لكل المواطنين وهذا لن يتحقق إلا بإقامة نظام اقتصادي جديد يقوم على الإنتاج الوافر عدالة التوزيع أي اقتصاد الكفاية والعدل وينهي أشكال الاقتصاد الاستهلاكية التابعة وهذا لا يتحقق أيضا إلا بمعارك مع القوى الرجعية والإمبريالية.
هذا هو الذي يفرض علينا أن نبني طلائع سياسية ونقابية وعسكرية وثقافية من نوع جديد وأحزابا ونقابات من نوع جديد وحركة شعبية من نوع جديد.
وبذلك نتقدم على طريق الوحدة التحرر والتحرير والتقدم السياسي الاجتماعي والديمقراطي ،أما بغير ذلك فسيكون لدينا عنف وقمع وحريات مهدورة وأحاديث عن الديمقراطية فقط ،وستظل التجزئة والتبعية ويستمر التخلف ويتواصل العنف والقمع.
هل يعني ذلك أننا قدمنا وصفة ناجحة لمعالج إشكاليات الديمقراطية؟.
أن كل ما طرحناه لا يطمح لأن يدعي ذلك لان الديمقراطية في العالم الصناعي مازالت تواجه إشكالات كبرى أهمها اثنتان :
الأولى هيمنة رأس المال على المجتمع وتحكمه بالسياسة والاقتصاد رغم ما فرضه الصراع من مكاسب للعمال الكادحين ورغم ما فرضه التنافس الرأسمالي من حرية منافسة وحقق فردية.
الثانية انتهاك الدول الرأسمالية لحقوق الأمم الأخرى، خاصة النامية وفرض شريعة الغاب عليها.لا يستطيع أحد حتى في الدول الرأسمالية أن ينكرها وبالتالي فأن هذا العالم الصناعي الذي رفع راية الديمقراطية يجعلها حرية الرأسمال داخل حدوده وهو يبتدلها في الحالتين ويصفها بمعنى الباحثين بالقول “إن ديمقراطية العالم الصناعي تفقد الإنسان إنسانيته”
ولذلك فإننا نواجه إشكاليات عدة ونحن ندعو إلى الديمقراطية،ونعمل لتحقيقها وهنا نجد من الضروري أن نؤكد على ما يلي :
– علينا أن نقتنع أن المشروع الديمقراطي مشروع نضال طويل المدى وأن علينا أن لا نفرق بينما نطمح إليه فيه وما نستطيع أن نحققه، فما نطمح إليه كبير وما نستطيع أن نحققه محدد وجزئي الآن وغدا، وإلى مدى ليس قريب،لأن تحقيق الديمقراطية مرتبط بمدى قدرتنا على بناء المجتمع المدني.
إن قيام الديمقراطية يتطلب وجد قوى ديمقراطية وبأن هذه القوى لا تقوم في ظل البنى الاجتماعية التقليدية،لا بإيديولوجيها القوى التقليدية، ووجود هذه القوى الديمقراطية يرتبط الآن وفي هذا العقد من القرن الواحد والعشرين بعملية إنتاج واسعة تتضمن قيام قوى مدنية منتجة وقيام ثقافة ديمقراطية لأن قوى الإنتاج الجديدة ترفض علاقات الإنتاج المتخلفة وتستطيع قوى الإنتاج الجديدة أن تستفيد من الثقافة الديمقراطية العالمية،ولكن الثقافة الديمقراطية العالمية في مجتمع خدمات مستهلك لا تنتج ثقافة عربية ديمقراطية ولا تبني مجتمعا عربيا ديمقراطيا.
– إن تحويل المجتمع من مجتمع خدمات استهلاكي إلى مجتمع إنتاج يحتاج إلى قوى العاملة والكادحة، وإلى طلائع سياسية وثقافية عسكرية شعبية تستطيع انتزاع السلطة من القوى الحاكمة.
– إن تكوين الحقل السياسي الديمقراطي يحتاج إلى خوض معركة الحريات السياسية ،غنها المعركة الضرورية لإضعاف القوى الباغية ولتعليم القوى الديمقراطية كيف تكون ديمقراطية ولتعميق معنى الديمقراطية لدى قوى الشعب العاملة والكادحة.
– إن الحرص على خوض المعركة الديمقراطية يتطلب نقد التجارب الحزبية السابقة نقدا واضحا صريحا وتحليل أسباب تكوينها غير الديمقراطي.
– أن إشراك جماهير واسعة في المعركة الديمقراطية وتعميق وعي البرنامج الديمقراطي لدى الجماهير هو الضمان الحقيقي لفرض البرنامج الديمقراطي ومنع قيام أنماط جديدة من السلطة القمعية ،لأن الجماهير وحدها،بوعيها وقدرتها هي القادرة على لجم العنف تصفيته ،وعلى الجماهير أن تعد صفوفها لهذه المعركة المعقدة والطويلة.
– ولهذا فإن معركة الديمقراطية في الوطن العربي مرتبطة بمعركة تحرير الوطن العربي وتوحيده وتهديم بنى التخلف والتبعية والتجزئة فيه، وإسقاط أنظمة العنف والقمع وبناء مجتمع عربي مدني ، أساس السيادة فيه إرادة الشعب ومصالحه ومطامحه وليس لها مصالح غير مصالحه ومطامح غير مطامحه.